الزمن الخصب في يوميات معلم في الجبل
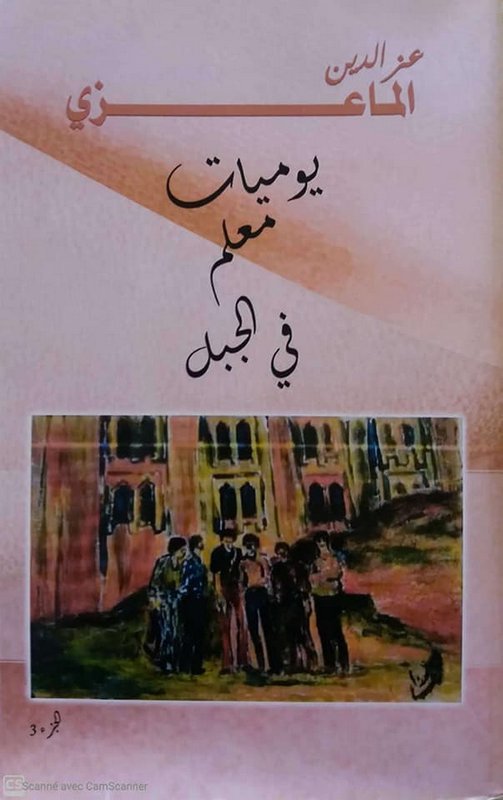
بقلم: إدريس الواغـيش
تنطلق هذه المقاربة النقدية وفق معالجة نصية تبتغي الملاءمة على خلفية مشتركة بين الإنتاج النصي والتلقي، لذلك نجدُ أنفسنا كقرّاء افتراضيين في هذه المجموعة القصصية « يَوميات مُعلم في الجَبل » أمام زمن خصب يُجدّد نفسه باستمرار وتجربة إنسانية مؤثرة تلخصها مجموعة من النصوص ذات أشكال تعبيرية متباينة، وهي في غالبيتها نصوص غير منغلقة، واضحة ومنفتحة على نفسها في أفقها المرجعي، لا تحتاج إلى تأويل أو وسيط من أجل تقريب مسافة الإدراك والفهم بين ما يرمي إليه عز الدين الماعزي (معلم الجبل) السارد والمؤلف والمسرود له أو المتلقي.
نصوص سير ذاتية جاءت في غالبها واضحة ومفهومة في سياقها اللغوي والافتراضي، تقرأ ذاتها بذاتها وتفكر في نفسها، صاغها المؤلف أو السارد من دون تشويش أو تزييف وتشويه، تكشف عن يوميات معلم تقاسمها وعاشها وتعايش معها كثير من الشباب المغربي في الجنوب بدءا من ثمانيات القرن العشرين، تمتد هذه اليوميات في المكان والزمان سواء في السهل أو الجبل. يقول السارد: « وأنتم أرسلتموني إلى الجنوب »، أقصد هنا الجنوب القصيّ الذي لم يسلم من التعيين فيه كثير من المعلمين في بدايات شبابهم. يتدرّج الماعزي في هذه اليوميات بدءا من الزّمن النفسي إلى الزّمن الواقعي والمتخيل، وهو زمن على اختلاف مراتبه وسيط يتجدّد باستمرار بين السارد والمسرود له، يقترب فيه الماضي من الحاضر وتظهر من خلاله نتوءات بعض ملامح المستقبل، يرتب فيها لرواسب ذاتية وزمن خاص. يوميات يتقاسمها معه في غالبها شخوص ومتلقون آخرون، رغم ما يبدو فيها من ذاتية وخصوصيات في ظاهر الأمر، تتجلى فيها الكثير من العناصر والتحولات في وحدتها، يوميات تغيب فيها الحدود الفاصلة بين أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل بكل امتداداتها في الزمن، يعيشها المؤلف بنفس النسق وإن اختلفت بعض التفاصيل، وتذوب فيها كثير من التجارب البشرية المختلفة. زمن خاص عاشه الماعزي سواء بصفته ساردا ومؤلفا أو معلما، لكن في نفس الوقت يشاركه فيه الآخرون بشكل افتراضي أو واقعي، تجربة ليست جامدة، لكنها لا تزال قائمة ومستمرة تتمدّد في الزمان والمكان، وإن كانت هناك فروق واضحة في العُمق » بين الذي يعيش التجربة والذي يسمع عنها » كما يقول السارد نفسه، لأن هناك فرق بين من يشرب الشاي الدافئ في البيت أو المقهى، وبين من يشرب » كأس الشاي البائت » وهو يعيش وحدته وعزلة منفردا في الليالي الباردة أعلى الجبل.
نصوص تذكرنا في مجملها بأجيال أقبرت أحلامها في الجنوب من خلال نصفها الفوقي العريان، لكن ثمة سجون أخرى مفتوحة ومن دون أسوار، وإن كانت غير مرئية، تتضمنها نصوص هذه السيرة الذاتية في جزئها الثالث، قضينا فيها فترات لا تقل « رُعْـبًا » وقلقا مع الكاتب. نصوص تعايشنا فيها مع الذئاب والثعالب والضباع في أعلى الجبل، وأحيانا مع الأفاعي السامة والفئران اللصوص وسكارى ما بعد منتصف الليل. يقول السارد: « حرق الأوراق هو تزامن لحرق أزمنة من جسدي »، يدفعنا السارد إلى أن نخوض معارك فكرية ونتحرك في أكثر من اتجاه حتى نصل إلى جوهر الحقيقة، لأن سلوكيات الإنسان هي على صعيد أنطيقي مشحونة بالهموم ويحدوها وجه من التفاتي في شيء ما، ولا يمكن لكينونة الكائن أن تفسر بواسطة الكائن نفسه في معزل عن المحيط الذي يعيش فيه، ولذلك كان لزمان أن تتوفر بعض القرائن المادية الإضافية الأخرى، وهو ما تأتّى لنا أن نقرأه لاحقا من قبيل: » الظاهر أن الحُجرة كانت طول الليل في أحضان بعض السّكارى » أو « فتحت الخزانة لكي أفاجأ بثعبان »، ذلك أن ماهية الكينونة في بعدها الظاهري هنا تكمن في أهمية الوُجود بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة وحتى التافهة. هذه الأشياء كلها هي التي نشير بها إلى الكائن، ولا يمكن أن ينوَجدُ إلا بها ومن خلال قوة مادية موازية. ويضيف السارد: « كل شيء أصبح فينا مُرقّمًا »، وهو يقصد أن يُعطوك رقم تأجير وورقة تحمل تعيينك بمدرسة في قمة جبل أعزل في الجنوب، وتصبح بعد ذلك (كائن) مُجرّد رقم يدور في فلك منظومة رقمية مجردة من كل الأحاسيس، وتصبح بعد ذلك باقي التفاصيل جامدة وباردة لا أهمية لها، حتى لو كانت غير مهمة في كينونتها وقد لا تترك بصمة في كينونة من عاشها كسارد وكاتب أو كمسرود له، بدءا من المدير وصولا إلى مجموعة من الأسئلة التي تفرضها بعض الانتظارات الصعبة، ومن خلالها ندرك الفهم الحقيقي للعالم الذي نعيش فيه: الرابيل (Rappel)، الترقية، المواصلات، حرارة منتصف النهار اللاذعة في الجنوب الشبه صحراوي بدءا من بداية فصل الربيع، تداخل السياسي مع النقابي في اشتباكات علائقية بأي تنظيم النقابي، « أعطي المُوعاليم جُوجْ دراهم دْوَا البْرغوت…! »، ضيافة الأهالي وكرمهم وبساطتهم…إلخ، حينها لا يمكن أن نفهم معنى الكينونة، بوصفها عالما صغيرا وليس كونا شاسعا ولا متناهيا وسط كل هذه التفاصيل، ونحن في خضمها لا نفهم حتى أنفسنا من حيث كونها جزء منها أو من كينونتنا.
تتغيّر صورة المرأة في مخيلتنا من موقع لآخر، ومن أكثر التشبيهات في الأدب الغربي لها عموما هو القيثارة بأوتارها وهي مستعدة دائما للعزف، أو كما يقول عنها جبران خليل جبران في كتابه: « دمعة وابتسامة »: « رأيت المرأة كالقيثارة بين يدي رجل لا يحسن الضرب عليها، فتسمعه أنغامًا لا ترضيه… »، لكن الماعزي السارد له رأي مغاير ومختلف في المرأة، إذ يقول عنها: « الجبل في صورة امرأة تهبني قوة وصبرا ونبيذا أبيض »، المرأة هي رمز للصبر والقوة والانتشاء(النبيذ الأبيض) والتشبيه كما ورد هنا ما هو إلا ترجمة لحكم الأمر الواقع، لأن توظيف (امتداد الجبل) كامرأة هو رؤية سيمائية للجبل بشكل يومي أمامه أو بكل ما يمثله من صبره وعطاء وسخاء أو ما يرمز إليه من رؤية إنسانية بكل إنسانيتها وحميميتها الدافئة، وقد كان الجبل (لأسباب نفسية)هو العالم الأقرب إلى المخيلة في الاستعمال والتشبيه في عملية السرد برمتها.
الصباح الذي ختم به الجزء الثالث من سيرته الذاتية جزء من الزّمن الدائري المتحرك، يوحي ببداية فصل جديد في زمن السرد، ويعكس في عمومه توظيفا دلاليا على الحركية والعمل وإيقاع الزمن النفسي الذي يتحرك في اتجاهين متناقضين لكن كل منهما يكمّل الآخر: الماضي والمستقبل، قد لا يسيران في اتجاه واحد، ما دام أن » كل صباح لا يشبه الآخر » كما جاء على لسان الماعزي السارد نفسه، ولذلك تصبح ملاحقة الزمن هنا ضرورية كأفق متعالي، ويصبح بدوره هو الآخر دلالة على خوض معركة فكرية نخوضها كل يوم مع الذات ومع الآخر، قبل أن نصل إلى جوهر الحقيقة في زمن يتشظي، في حياتنا كما في اليوميات، كل يوم وفي كل لحظة، عكس المساء الذي يفضي إلى النقيض من ذلك تماما، سواء من حيث كونه يشير إلى السكون والسكينة أو الصمت، والصمت كما نعلم قد يقصُـرُ أو يطول ويصبح حينها موتا أو زمنا أبديا، وما بين الواقعي والمتخيل في اليوميات، على قلته، تختلط أوراق المؤلف وتتداخل فيما بينها، إذ « لا تمر الأنثى على مكان إلا وأحيته » وكأنها ماء يحيي الإنسان كما الأرض البوار بصفتها مصدرا للحياة، وتصبح المفهومية الوسطية هنا لا تبرهن إلا عن عدم المفهومية نفسها، وهو مفهوم نفسي بالدرجة الأولى محفوف بالغموض بين الرؤية النفسية والواقع أو الوهم والتمني.
الزمن في « يوميات معلم في الجبل » ليس على مستوى واحد من الحكي ولا تحكمه معايير موحدة، إذ أن هناك زمن خصب متجدد وآخر مادي موضوعي يتمثل في « المَانْضَا الصّفرا »، وهو زمن عايشه وعاش فيه كثير من الموظفين في المغرب وليس موظفو التعليم وحدهم، قبل أن يتطور النظام البنكي والخدماتي في المغرب. هكذا تصبح الكتابة عند الماعزي- السارد نوعا من الامتلاء الداخلي أو التصوير الذاتي (L’ autoreprésentations)، يتحقق السرد فيها من خلال مستويات متعددة وضمائر متعددة وخصوصا: ضمير الـ (هو) الغائب وضمير الـ (أنا) المتكلم، ومن هنا وجب علينا ألا نخوض في غمار جماليات اللغة ضمن مجمل نصوص السارد التي جاءت في مجملها واضحة، إذ لم يحاول السارد فيها إرباك القارئ وإغراق السرد في هذه اليوميات من خلال تنويع التشبيهات والألاعيب اللغوية، ليس لأنه عاجر عن فعل ذلك، لكن بحكم صدقيته في الحكي، جاء السرد تلقائي بشكل طبيعي وعفوي غير مغشوش أو مشوه بأسلوبية السُّـرّاد الماكرة.




Aucun commentaire